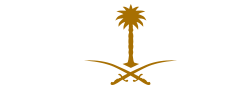سكاي نيوز عربية - 9/15/2025 1:30:28 PM - GMT (+3 )

أحدث حلقات هذا المشهد تمثلت في استقبال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض للقائد العام للشرطة الإيرانية في بغداد، في اجتماع حمل عنوان "التعاون الأمني المشترك"، لكن دلالاته بدت أوسع بكثير من جدول الأعمال المعلن.
اللقاء جاء في توقيت حساس، بعد أيام قليلة من قرار مجلس الوزراء العراقي بمنح منتسبي الحشد الشعبي أراضي سكنية واسعة في البصرة، لإقامة مدينة متكاملة لاحقاً.
خطوة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الامتيازات المتزايدة التي تمنح لهذا الجهاز الأمني المثير للجدل، وحول الدور الإيراني المحتمل في دعم هذه المسارات.
فما هي الرسائل التي يحملها اجتماع الفياض مع مسؤول أمني إيراني رفيع؟ وأين يقف العراق بين السيادة الوطنية وتوازناته الإقليمية؟
لقاء طبيعي في إطار رسمي
رأى عضو المرصد الوطني للإعلام في العراق، وائل الركابي، في مداخلته لـ"رادار" أن الاجتماع لا يخرج عن إطار السياقات الطبيعية للدولة العراقية.
وأوضح أن الفياض ليس سوى رئيس هيئة أمنية دستورية وفاعلة، سبق أن التقى بمسؤولين أمنيين من دول جوار مثل تركيا.
وفق هذا المنطق، فإن اجتماع الفياض مع قائد الشرطة الإيرانية لا يحمل دلالات استثنائية، بل يندرج ضمن زيارة رسمية تتعلق بملفات حساسة: تأمين المنافذ الحدودية، مواجهة تهريب السلاح، وتنظيم الزيارات الدينية عبر الحدود.
ويضيف الركابي أن الحشد الشعبي، كجزء من المنظومة الأمنية العراقية، لديه مواقع انتشار على الحدود مع إيران وفي مناطق أخرى، ما يجعل الحوار المباشر مع نظيره الإيراني أمراً عملياً لا شبهة فيه.
الأهم، من وجهة نظره، أن الاجتماع جاء مكملا لاتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وطهران قبل أقل من شهر، وبالتالي فهو تنفيذ لبنودها. وبناءً على ذلك، يؤكد الركابي أن ما يجري لا يعني إطلاقاً أن العراق "ينضوي تحت الإرادة الإيرانية" كما يحاول البعض تصويره.
كما شدّد على أن الحشد الشعبي يحظى بخصوصية دستورية تمنحه مرونة في الانتشار والمهام، شأنه شأن جهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني.
فالقانون الذي أقر عام 2016 شرعن وجوده، وجعله تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، ما يمنحه شرعية قانونية كاملة ويقطع الطريق على التشكيك بولائه الوطني.
خلل بروتوكولي ورسائل إيرانية مبطنة
لكن الخبير الاستراتيجي إحسان القيسون قدّم مقاربة مغايرة تماماً. فهو يرى أن ما يحدث يكشف عن خلل بروتوكولي وعسكري خطير، إذ إن المسؤول الأمني الإيراني كان ينبغي أن يلتقي وزير الداخلية أو رئيس أركان الجيش العراقي، لا رئيس هيئة الحشد الشعبي.
القيسون تساءل بوضوح: لماذا لا نرى لقاءات مماثلة بين الحشد الشعبي ومسؤولين عسكريين وأمنيين من دول عربية، كما يحدث مع نظرائهم الإيرانيين؟.. فقد زار العراق قادة أمنيون من الكويت والسعودية والأردن ومصر، لكنهم لم يلتقوا بالحشد، بينما يحرص القادة الإيرانيون على الاجتماع به بشكل متكرر.
في رأيه، هذا يكشف أن إيران تنظر إلى الحشد الشعبي باعتباره حليفاً مباشراً لها، بل وأحد تشكيلات الحرس الثوري الإيراني.
المعضلة، كما يصفها القيسون، أن الحشد الشعبي يعمل وسط شبكة من "الثنائيات" التي تربك المشهد: السلاح والسياسة، المذهب والوطنية، المقاومة والدولة.
هذا التداخل جعل منه جسماً لا يمكن ضبط صلاحياته بوضوح، في ظل تعدد مراكز القوى داخل العراق. والنتيجة هي إضعاف القرار الأمني والعسكري الرسمي، وتشويش في أدوار المؤسسات: الدفاع، الداخلية، المخابرات، الأمن الوطني.
الأكثر خطورة، وفق القيسون، أن بعض قادة الحشد يعلنون صراحة التزامهم بأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي، ما يثير شكوكاً جدية حول ولاءاتهم. فكيف يمكن لمؤسسة عسكرية عراقية أن تخضع في الوقت ذاته لقيادة عليا خارج الحدود؟
بين شرعية القانون وواقع النفوذ
الجدل بين الركابي والقيسون يعكس ازدواجية المشهد العراقي. فمن الناحية القانونية، الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أقرها البرلمان بقانون عام 2016، وهو ما يمنحها شرعية لا يمكن الطعن بها بسهولة. لكن من الناحية السياسية، ارتباطاتها العقائدية وتواصلها المباشر مع طهران يضعها في قلب معادلة النفوذ الإيراني.
وهنا تكمن المفارقة: الدولة العراقية ترى في الحشد ذراعاً أمنية خاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، بينما تنظر إليه إيران بوصفه حليفاً استراتيجياً وخط دفاع متقدم عن مصالحها. هذا التباين في الرؤى يفسر الحساسية التي يثيرها كل لقاء يجمع قياداته بمسؤولين إيرانيين.
الامتيازات والخصوصية.. الأراضي نموذجاً
قرار مجلس الوزراء العراقي الأخير بمنح منتسبي الحشد الشعبي أراضي سكنية واسعة في البصرة، لتطوير مدينة متكاملة لاحقاً، يعكس حجم الامتيازات المتزايدة التي يحصل عليها الحشد. بالنسبة لمؤيديه، هذا حق مشروع لعراقيين ضحوا بدمائهم في مواجهة داعش. لكن بالنسبة لمنتقديه، هو تكريس لمكانة موازية للمؤسسات الرسمية، وتحويل الحشد إلى "جيش رديف" داخل الدولة.
الركابي دافع عن القرار، مؤكداً أن الأرض عراقية، والتمويل عراقي، ولا علاقة لإيران به، تماماً كما تمنح وزارات أخرى موظفيها أراضي سكنية. في المقابل، القيسون يرى أن هذه الامتيازات تكرس تميز الحشد وتفصله أكثر عن باقي الأجهزة، ما يعزز صورة أنه جهاز فوق العادة، أقرب إلى مؤسسة سياسية ـ عسكرية لها امتداد إقليمي.
رسائل اللقاء: ثلاث دوائر أساسية
- للداخل العراقي: اللقاء يكرس الحشد كجسم رديف، يُعامل بمقام "وزارة أمنية"، ويحظى بامتيازات خاصة، بما يعيد النقاش حول دوره المستقبلي: هل يبقى مؤسسة عسكرية وطنية، أم يتحول إلى كيان سياسي ـ أمني مستقل؟.
- للإيرانيين: استمرار الاجتماعات المباشرة مع قيادات الحشد يثبت أن العراق يظل مجالاً حيوياً وخط دفاع أول لإيران، وأن نفوذها داخل بغداد مضمون عبر هذه القناة حتى في أحلك الظروف.
- للخارج العربي والدولي: بينما تحاول بغداد التأكيد على سيادتها واستقلال قرارها، فإن الواقع الميداني يعكس استمرار النفوذ الإيراني عبر الحشد، ما يعقد صورة العراق أمام شركائه العرب والغربيين.
أزمة السيادة وتعدد الولاءات
المسألة إذن ليست في اجتماع بروتوكولي واحد، بل في ما يعكسه من مأزق أعمق: السيادة العراقية المهددة بتعدد مراكز القوى. فالحشد الشعبي، بقوام يقارب 300 ألف مقاتل اليوم، لم يعد مجرد تشكيل مقاوم وُلد من رحم الحرب على داعش، بل بات مؤسسة ضخمة بامتيازات واسعة، وقنوات اتصال إقليمية خاصة.
الركابي يصر على أن هذه الامتيازات لا تعني خضوعاً لإيران، وأن أي تصريح بدعم دولة خارجية على حساب العراق يعد خيانة. لكن القيسون يشير إلى أن المشكلة تكمن في تكرار الاجتماعات خارج السياق الرسمي، وفي تصريحات بعض القيادات التي تؤكد ارتباطها العقائدي بإيران.
النتيجة أن العراق يجد نفسه أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على توازن علاقاته الإقليمية، ويثبت استقلالية قراره، بينما يتعامل مع واقع قوة داخلية تحظى بدعم خارجي معلن؟
العراق بين خيارين
لقاء الفياض مع القائد العام للشرطة الإيرانية ليس الأول ولن يكون الأخير، لكنه يكشف بوضوح عن معضلة بنيوية: العراق محكوم بشبكة معقدة من التوازنات بين الدولة الرسمية ومراكز القوى غير الرسمية.
الحشد الشعبي يقف في قلب هذه الشبكة، كرمز للسيادة الوطنية عند أنصاره، وكأداة نفوذ إيرانية عند منتقديه.
الركابي والقيسون، برؤيتين متناقضتين، جسّدا هذا الانقسام: الأول يرى في الحشد مؤسسة عراقية صرفة، والآخر يراه جسراً مفتوحاً أمام طهران.
وبين الرؤيتين، تبقى الحقيقة أن كل اجتماع من هذا النوع يطرح الأسئلة نفسها: من يمسك بزمام القرار في العراق؟ وإلى أي حد يمكن أن تصمد السيادة الوطنية أمام إغراءات الجغرافيا وضغوط الجوار؟.
في النهاية، يتضح أن معركة العراق ليست فقط على الأرض أو في أروقة السياسة، بل أيضاً على تعريف السيادة نفسها: هل هي قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها دون تدخل خارجي، أم قدرتها على موازنة نفوذ الحلفاء والجيران من دون أن تفقد استقلالها؟.
إقرأ المزيد